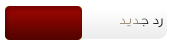سورة الأحزاب
[ من الآية (63) إلى الآية (68) ]
{يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا (63) إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا (64) خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَّا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا (65) يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا (66) وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا (67) رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا (68)}
قوله تعالى: {يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا (63)}
قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا (64)}
قوله تعالى: {خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَّا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا (65)}
قوله تعالى: {يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا (66)}
قال أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسيّ (ت: 377هـ): (اختلفوا في قوله تعالى: (الظنونا) [الأحزاب/ 10]، و (الرسولا) [الأحزاب/ 66]، و (السبيلا) [الأحزاب/ 67].
فقرأ ابن كثير وعاصم في رواية حفص والكسائي بألف إذا وقفوا عليهنّ وبطرحها في الوصل.
وقال هبيرة: عن حفص عن عاصم وصل أو وقف بألف. وقرأ عاصم في رواية أبي بكر ونافع وابن عامر بألف فيهنّ في الوصل والوقف. وقرأ أبو عمرو بغير ألف في الوصل والوقف هذه رواية
[الحجة للقراء السبعة: 5/468]
اليزيدي وعبد الوارث وروى عبّاس عن أبي عمرو بألف فيهنّ في الوصل والوقف. وروى علي بن نصر عن أبي عمرو: السبيلا يقف عندها بألف. أبو زيد عن أبي عمرو: الظنونا، والرسولا. والسبيلا، يقف ولا يصل ووقفه بألف. عبيد عن هارون عن أبي عمرو يقف عندها الرسولا. وحدّثني الجمال عن الحلواني عن روح عن أحمد بن موسى عن أبي عمرو بألف فيهنّ وصل أو قطع.
قال أبو علي: وجه قول من أثبت في الوصل الألف أنّها في المصحف كذلك، وهي رأس آية. ورءوس الآي تشبّه بالفواصل من حيث كانت مقاطع، كما كانت القوافي مقاطع، فكما شبّه أكرمن [الفجر/ 15] وأهانن [الفجر/ 16] بالقوافي. في حذف الياء منهنّ نحو:
من حذر الموت أن يأتين و: إذا ما انتسبت له أنكرن كذلك يشبّه هذا في إثبات الألف بالقوافي. فأمّا في الوصل، فلا
[الحجة للقراء السبعة: 5/469]
ينون، ويحمل على لغة من لم ينوّن ذلك إذا وصل في الشعر لأنّ من لم ينوّن أكثر. وقال أبو الحسن: وهي لغة أهل الحجاز، فكذلك، فأضلونا السبيلا [الأحزاب/ 67]، وأطعنا الرسولا [الأحزاب/ 66]. فأمّا من طرح الألف في الوصل كابن كثير والكسائي، فإنّهم ذهبوا إلى أنّ ذلك في القوافي، وليس رءوس الآي بقواف، فتحذف في الوقف كما، تحذف في غيرها، ممّا يثبت في الوقف نحو التشديد الذي يلحق الحرف الموقوف عليه، وهذا إذا ثبت في الخطّ فينبغي أن لا يحذف، كما لا تحذف هاء الوقف من حسابيه [الحاقة/ 20] وكتابيه [الحاقة/ 19] وأن يجري مجرى الموقوف عليه، ولا يوصل، وكذلك الهاء التي تلحق في الوقف، فهو وجه، فإذا ثبت ذلك في القوافي في الوصل فيما حكاه أبو الحسن، لأنّه زعم أن هذه اللّغة أكثر، فثبات ذلك في الفواصل، كما يثبت في القوافي حسن). [الحجة للقراء السبعة: 5/470] (م)
قال أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي (ت: 392هـ): (ومن ذلك قراءة عيسى بن عمر الكوفي: [يَوْمَ تُقَلِّبُ وُجُوهَهُمْ]، نصب.
قال أبو الفتح: الفاعل في [تُقَلِّبُ] ضمير السعير المقدم الذكر في قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا، خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا}، ثم قال: [يَوْمَ تُقَلِّبُ]، أي: تُقَلِّبُ السعيرُ وجوههم في النار، فنسب الفعل إلى النار، وإن كان المُقَلِّبُ هو الله سبحانه، بدلالة قراءة أبي حيوة: [يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهَهُمْ]، لأنه إذا كان التقليب فيها جاز أن ينسب الفعل إليها للملابسة التي بينهما، كما قال الله: {بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ}، فنسب المكر إليهما لوقوعه فيهما، وعليه قول رؤبة:
فَنَامَ لَيْلِي وتَجَلَّى هَمِّي
أي: نمتُ في ليلِي: وعليه نفى جرير الفعل الواقع فيه عنه فقال:
لقد لُمْتِنا يا أمَّ غَيلانَ في السُّرَى ... ونِمتِ ومَا لَيْلُ المطِيِّ بنائمِ
فهذا نفي لمن قال: نام لَيْلُ المطِيِّ، وتطرقوا من هذا الاتساع إلى ما هو أعلى منه، فعليه بيت الكتاب:
أما النهارُ فَفِي قَيْدٍ وسِلْسِلةٍ ... والليلُ فِي جَوفٍ منحُوتٍ من السَّاجِ
فجعل النهار نفسه في القيدِ والسلسلةِ، والليلَ نفسَه في جوفِ المنحوتِ. وإنما يريد أن هذا المذكور في نهاره في القيد والسلسلة، وفي ليله في بطن المنحوت. وقد جاء هذا في الأماكن أيضا، وعليه قول رؤبة:
ناجٍ وقدْ زَوْزَى بنا زِيزَاؤه
[المحتسب: 2/184]
فالزيزاء على فعلاء، وهي هذه الغليظة المنقادة من الأرض، فكأن هذه الأرض سارت بهم الفجاج؛ لأنهم ساروا عليها. وقد يمكن أن يكون "زيزاؤه" مصدر من زَوْزَيْتُ، فيكون الفعل منسوبا إلى المصدر، كقولهم: سار بنا السيرُ، وقام بهم القيامُ. فهو على قولك: سيرٌ سائرٌ، وقيامٌ قائمٌ. ومنه: شعرٌ شاعرٌ، وموتٌ مائتٌ، وويلٌ وائلٌ. والزيزاء على هذا فِعلال، كالزلزال، والقلقال.
وأما قول رؤبة:
هيهاتَ من منخرقٍ هيهاؤه
فهو فعلال من لفظ. هيهات، كالزلزال، والقلقال، وليس مصدرا صريحا. وهيهات من مضاعف الياء، ومن باب الصِّيصِية وقد تقدم القول عليه). [المحتسب: 2/185]
قال مكي بن أبي طالب القَيْسِي (ت: 437هـ): (4- قوله: {الظنونا} و{الرسولا} و{السبيلا} قرأ نافع وابن عامر وابو بكر بألف في الثلاثة، في الوصل والوقف، وكذلك حفص وابن كثير
[الكشف عن وجوه القراءات السبع: 2/194]
والكسائي غير أنهم يحذفون الألف في الوصل، وقرأ الباقون بحذف الألف في الوصل والوقف وكلهم قرأ: {وهو يهدي السبيل} «الأحزاب 4» و{أم هم ضلوا السبيل} «الفرقان 17» بغير ألف في الوصل والوقف.
وحجة من أثبت الألف في الوصل أنه اتبع الخط، فهي في المصحف بألف، وإنما كتبت بألف لأنها رأس آية، فأشبهت القوافي من حيث كانت كلها مقاطع الكلام، وتمام الأخبار.
5- وحجة من حذف الألف في الوصل أنه أتى به على الأصل؛ إذ لا أصل لألف فيه كله، وفرق ما بين هذا والقوافي أن القوافي موضع وقف وسكون، وهذا لا يلزم فيه الوقف والسكون.
6- وحجة من أثبت الألف في الوقف أنه اتبع الخط، فوقف على ما فيه خط المصحف.
7- وحجة من حذف الألف في الوقف أنه أجرى الوقف مجرى الوصل، فحذف في الوقف كما حذف في الوصل؛ لأن الألفات فيها لا أصل لها، إنما جيء بها على التشبيه بالقوافي والفواصل، والاختيار إثبات الألف في الوصل والوقف اتباعًا للمصحف). [الكشف عن وجوه القراءات السبع: 2/195] (م)
قوله تعالى: {وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا (67)}
قال أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري (ت: 370هـ): (وقوله جلّ وعزّ: (إنّا أطعنا سادتنا وكبراءنا (67)
قرأ ابن عامر والحضرمي (إنّا أطعنا ساداتنا) بألف بعد الدال، وكسر التاء.
وقرأ الباقون (سادتنا) بلا ألف مع فتح التاء.
قال أبو منصور: يقال: سيد، وسادة، للجمع، ثم سادات جمع الجمع.
والتاء مكسورة في (ساداتنا)؛ لأنها تاء الجميع في موضع النصب،
[معاني القراءات وعللها: 2/285]
وأما تاء (سادة) فهي في الأصل هاء، كهاء (فعلة) ولذلك لم يكسر). [معاني القراءات وعللها: 2/286]
قال أبو عبد الله الحسين بن أحمد ابن خالويه الهمَذاني (ت: 370هـ): (13- وقوله تعالى: {إنا أطعنا سادتنا وكبرآءنا} [67].
قرأ ابن عامر وحده: {سادتنا} بالألف وكسر التاء، كأنه جعله جمع الجمع؛ لأن سادة جمع سيد، وسادات جمع الجمع، فسادة جمع التكسير يجري آخره، بوجوه الإعراب، ومن قال: سادات فهو جمع السلامة نصبه كجره، فالتاء مكسورة في حال النصب، كقولك: رأيت بناتك و: {إن السموات والأرض كانتا رتقا}.
وحدثني أحمد عن على عن أبي عبيد أن الحسين قرأ: {أطعنا سادتنا} مثل ابن عامر). [إعراب القراءات السبع وعللها: 2/206]
قال أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسيّ (ت: 377هـ): (اختلفوا في قوله تعالى: (الظنونا) [الأحزاب/ 10]، و (الرسولا) [الأحزاب/ 66]، و (السبيلا) [الأحزاب/ 67].
فقرأ ابن كثير وعاصم في رواية حفص والكسائي بألف إذا وقفوا عليهنّ وبطرحها في الوصل.
وقال هبيرة: عن حفص عن عاصم وصل أو وقف بألف. وقرأ عاصم في رواية أبي بكر ونافع وابن عامر بألف فيهنّ في الوصل والوقف. وقرأ أبو عمرو بغير ألف في الوصل والوقف هذه رواية
[الحجة للقراء السبعة: 5/468]
اليزيدي وعبد الوارث وروى عبّاس عن أبي عمرو بألف فيهنّ في الوصل والوقف. وروى علي بن نصر عن أبي عمرو: السبيلا يقف عندها بألف. أبو زيد عن أبي عمرو: الظنونا، والرسولا. والسبيلا، يقف ولا يصل ووقفه بألف. عبيد عن هارون عن أبي عمرو يقف عندها الرسولا. وحدّثني الجمال عن الحلواني عن روح عن أحمد بن موسى عن أبي عمرو بألف فيهنّ وصل أو قطع.
قال أبو علي: وجه قول من أثبت في الوصل الألف أنّها في المصحف كذلك، وهي رأس آية. ورءوس الآي تشبّه بالفواصل من حيث كانت مقاطع، كما كانت القوافي مقاطع، فكما شبّه أكرمن [الفجر/ 15] وأهانن [الفجر/ 16] بالقوافي. في حذف الياء منهنّ نحو:
من حذر الموت أن يأتين و: إذا ما انتسبت له أنكرن كذلك يشبّه هذا في إثبات الألف بالقوافي. فأمّا في الوصل، فلا
[الحجة للقراء السبعة: 5/469]
ينون، ويحمل على لغة من لم ينوّن ذلك إذا وصل في الشعر لأنّ من لم ينوّن أكثر. وقال أبو الحسن: وهي لغة أهل الحجاز، فكذلك، فأضلونا السبيلا [الأحزاب/ 67]، وأطعنا الرسولا [الأحزاب/ 66]. فأمّا من طرح الألف في الوصل كابن كثير والكسائي، فإنّهم ذهبوا إلى أنّ ذلك في القوافي، وليس رءوس الآي بقواف، فتحذف في الوقف كما، تحذف في غيرها، ممّا يثبت في الوقف نحو التشديد الذي يلحق الحرف الموقوف عليه، وهذا إذا ثبت في الخطّ فينبغي أن لا يحذف، كما لا تحذف هاء الوقف من حسابيه [الحاقة/ 20] وكتابيه [الحاقة/ 19] وأن يجري مجرى الموقوف عليه، ولا يوصل، وكذلك الهاء التي تلحق في الوقف، فهو وجه، فإذا ثبت ذلك في القوافي في الوصل فيما حكاه أبو الحسن، لأنّه زعم أن هذه اللّغة أكثر، فثبات ذلك في الفواصل، كما يثبت في القوافي حسن). [الحجة للقراء السبعة: 5/470] (م)
قال أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسيّ (ت: 377هـ): (قال: كلّهم قرأ سادتنا [الأحزاب/ 67] على التوحيد غير ابن عامر فإنّه قرأ (ساداتنا) جماعة [سادة.
قال أبو علي]: سادة جمع سيّد وهو فعلة مثل كتبة وفجرة، أنشدنا عليّ بن سليمان:
سليل قروم سادة ثم قادة... يبذّون أهل الجمع يوم المحصّب
ووجه الجمع بالألف والتاء أنّهم قد قالوا الجرزات والطّرقات والمعنات في معن جمع معين، فكذلك يجوز في هذا الجمع سادات وقال الأعشى:
جندك التالد الطّريف من ال... سّادات أهل القباب والآكال
[الحجة للقراء السبعة: 5/480]
قال أبو الحسن: لا يكادون يقولون: سادات. قال وهي عربية، وزعموا أنّ الحسن قرأ (أطعنا ساداتنا) ). [الحجة للقراء السبعة: 5/481]
قال أبو زرعة عبد الرحمن بن محمد ابن زنجلة (ت: 403هـ) : ({إنّا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا * ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا} 67 و68
[حجة القراءات: 579]
قرأ ابن عامر (إنّا أطعنا ساداتنا) بالألف وكسر التّاء جعله جمع الجمع لأن سادة جمع سيد وسادات جمع الجمع فسادة جمع التكسير يجري آخره بوجوب الإعراب ومن قرأ (ساداتنا) فهي جمع السّلامة نصب لجره والتّاء مكسورة في حال النصب كقوله أن السّموات وقال بعض النّحويين سادة جمع سائد مثل قائد وقادة وهي جمع التكسير وليس بجمع سيد لأن السّيّد يجمع سيدين مثل ميت تقول في جمعه ميتون وأموات كما قال {إنّك ميت وإنّهم ميتون} وقال {أموات غير أحياء} وسائد وسيد بمعنى واحد وسيد أبلغ في المدح
وقرأ الباقون {سادتنا} بغير ألف وفتح التّاء جمع سيد وقد ذكرنا). [حجة القراءات: 580]
قال مكي بن أبي طالب القَيْسِي (ت: 437هـ): (4- قوله: {الظنونا} و{الرسولا} و{السبيلا} قرأ نافع وابن عامر وابو بكر بألف في الثلاثة، في الوصل والوقف، وكذلك حفص وابن كثير
[الكشف عن وجوه القراءات السبع: 2/194]
والكسائي غير أنهم يحذفون الألف في الوصل، وقرأ الباقون بحذف الألف في الوصل والوقف وكلهم قرأ: {وهو يهدي السبيل} «الأحزاب 4» و{أم هم ضلوا السبيل} «الفرقان 17» بغير ألف في الوصل والوقف.
وحجة من أثبت الألف في الوصل أنه اتبع الخط، فهي في المصحف بألف، وإنما كتبت بألف لأنها رأس آية، فأشبهت القوافي من حيث كانت كلها مقاطع الكلام، وتمام الأخبار.
5- وحجة من حذف الألف في الوصل أنه أتى به على الأصل؛ إذ لا أصل لألف فيه كله، وفرق ما بين هذا والقوافي أن القوافي موضع وقف وسكون، وهذا لا يلزم فيه الوقف والسكون.
6- وحجة من أثبت الألف في الوقف أنه اتبع الخط، فوقف على ما فيه خط المصحف.
7- وحجة من حذف الألف في الوقف أنه أجرى الوقف مجرى الوصل، فحذف في الوقف كما حذف في الوصل؛ لأن الألفات فيها لا أصل لها، إنما جيء بها على التشبيه بالقوافي والفواصل، والاختيار إثبات الألف في الوصل والوقف اتباعًا للمصحف). [الكشف عن وجوه القراءات السبع: 2/195] (م)
قال مكي بن أبي طالب القَيْسِي (ت: 437هـ): (21- قوله: {سادتنا} قرأه ابن عامر بالجمع، فهو جمع الجمع، على إرادة التكثير، لكثرة من أضلهم وأغواهم من رؤسائهم، فهو جمع سادة، جمع مسلم بالألف والتاء، وقرأ الباقون «سادتنا» على أنه جمع «سيد» فهو يدل على القليل والكثير لأنه جمع مكسر). [الكشف عن وجوه القراءات السبع: 2/199]
قال نصر بن علي بن أبي مريم (ت: بعد 565هـ) : (20- {سَادَاتِنَا} [آية/ 67] بالألف بعد الدال، وبكسر التاء:
قرأها ابن عامر ويعقوب.
والوجه أنه جمع سادة، جُمعت بالألف والتاء وإن كانت السادة جمعًا، كما قالوا الطرقات والبيوتات وصواحبات يوسف.
وقرأ الباقون {سَادَتَنَا} بغير ألف، مفتوحة التاء.
والوجه أنه جمع سيد أو سائد، فكلاهما واحدٌ في المعنى، وفعلةٌ في جمع فاعلٍ كثيرٌ، ومثله قائد وقادةٌ، ومن الصحيح: كاتبٌ وكتبةٌ وفاجرٌ وفجرةٌ). [الموضح: 1040]
قوله تعالى: {رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا (68)}
قال أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري (ت: 370هـ): (وقوله جلّ وعزّ: (لعنًا كثيرًا (68)
قرأ عاصم وحده (لعنًا كبيرًا) بالباء.
وقرأ الباقون (كثيرًا) بالثاء.
قال أبو منصور: معنى الكبير والكثير متقارب، والثاء أكثر واللّه أعلم). [معاني القراءات وعللها: 2/286]
قال أبو عبد الله الحسين بن أحمد ابن خالويه الهمَذاني (ت: 370هـ): (14- وقوله تعالى: {والعنهم لعنا كبيرًا} [68].
قرأ عاصم وابن عامر بالباء.
وقرأ الباقون: {كثيرًا} بالثاء، وقد أنبأت عن علته في (البقرة) عند قوله: {فيهما إثم كبير} ومعنى اللعن في اللغة: الطرد.
[إعراب القراءات السبع وعللها: 2/206]
قال الشماخ:
ذعرت به القطا ونفيت عنه = مقام الذئب كالرجل اللعين). [إعراب القراءات السبع وعللها: 2/207]
قال أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسيّ (ت: 377هـ): (اختلفوا في الباء والثاء من قوله جلّ وعزّ: لعنا كبيرا [الأحزاب/ 68] فقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي: (لعنا كثيرا) بالثاء، وقرأ عاصم وابن عامر: كبيرا بالباء كذا في كتابي عن أحمد بن يوسف التغلبي عن ابن ذكوان [عن ابن عامر]، ورأيت في كتاب موسى بن موسى عن ابن ذكوان عن ابن عامر بالثاء، وقال هشام بن عمّار عن ابن عامر بالثاء.
قال أبو علي: الكبر مثل العظم، والكبر وصف للّعن بالكبر، كالعظم، والكثرة أشبه بالمعنى، لأنّهم يلعنون مرّة، وقد جاء: يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون [البقرة/ 159] فالكثرة أشبه بالمرار المتكررة من الكبر). [الحجة للقراء السبعة: 5/481]
قال أبو زرعة عبد الرحمن بن محمد ابن زنجلة (ت: 403هـ) : (قرأ عاصم {والعنهم لعنا كبيرا} بالباء أي عظيما فالكبر مثل العظم والكبر وصف للفرد كالعظم
وقرأ الباقون {كثيرا} بالثاء أي جما فالكثرة اشبه بالمعنى لأنهم يلعنون بمرّة بعد مرّة وقد جاء {يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون}). [حجة القراءات: 580]
قال مكي بن أبي طالب القَيْسِي (ت: 437هـ): (22- قوله: {لعنًا كبيرًا} قرأه عاصم بالباء، وقرأ الباقون بالثاء.
وحجة من قرأ بالثاء أنه جعله من الكثرة على أنهم يلعون مرة بعد مرة بدلالة.
قوله: {يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون} «البقرة 159» فهذا يدل على كثرة التلعن لهن، فالكثرة أشبه بتكرير اللعن لهم من الكبر.
23- وحجة من قرأ بالباء أنه لما كان الكبر مثل «العظم» في المعنى، وكان كل شيء كبيرًا عظيمًا دل العظم على الكثرة وعلى الكبر، فتضمنت القراءة بالباء المعنيين جميعًا، الكبرة والكثرة، والاختيار الثاء، لأن الجماعة عليه). [الكشف عن وجوه القراءات السبع: 2/200]
قال نصر بن علي بن أبي مريم (ت: بعد 565هـ) : (21- {لَعْنًا كَبِيرًا} [آية/ 68] بالباء:
قرأها عاصم وحده.
والوجه أنه أراد لعنًا عظيمًا؛ لأن الكبر والعِظَم في معنىً واحدٍ، وقيل: بل أراد بالكبر أنه لا ينقطع.
وقرأ الباقون {لَعْنًا كَثِيرًا} بالثاء.
والوجه أنه أراد تكرر اللعن، فأطلق لفظ الكثرة لذلك). [الموضح: 1040]