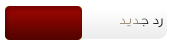{وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (16) إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (17) وَإِنْ تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (18) أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (19) قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآَخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (20) يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ (21) وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (22) وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآَيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِي وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (23) فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (24) وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ (25) فَآَمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (26) وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآَتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآَخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ (27) وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ (28) أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (29) قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ (30) وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ (31) قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ (32) وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ (33) إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (34) وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آَيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (35) }
تفسير قوله تعالى: {وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (16)}
قال يَحيى بن سلاَّم بن أبي ثعلبة البصري (ت: 200هـ): (قوله عزّ وجلّ: {وإبراهيم} [العنكبوت: 16]، أي: وأرسلنا إبراهيم إلى قومه، وهذا تبعٌ للكلام الأوّل لقوله في نوحٍ: {ولقد أرسلنا نوحًا إلى قومه} [العنكبوت: 14] قال: {إذ قال لقومه اعبدوا اللّه} [العنكبوت: 16]، يعني: وحّدوا اللّه.
{واتّقوه} [العنكبوت: 16] يقول: واخشوه وهو تفسير السّدّيّ.
{ذلكم خيرٌ لكم إن كنتم تعلمون {16}). [تفسير القرآن العظيم: 2/622]
قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ السَّرِيِّ الزَّجَّاجُ (ت: 311هـ)
: (وقوله: {وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا اللّه واتّقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون (16)}
المعنى : وأرسلنا إبراهيم عطفا على نوح.). [معاني القرآن: 4/164]
تفسير قوله تعالى: {إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (17)}
قال يَحيى بن سلاَّم بن أبي ثعلبة البصري (ت: 200هـ): ({إنّما تعبدون من دون اللّه أوثانًا وتخلقون} [العنكبوت: 17]، أي: وتصنعون.
{إفكًا} [العنكبوت: 17]، يعني: كذبًا كقوله: {أتعبدون ما تنحتون} [الصافات: 95] وقال مجاهدٌ: قال: {وتخلقون إفكًا} [العنكبوت: 17] يقول كذبًا.
وقال السّدّيّ: {وتخلقون إفكًا} [العنكبوت: 17]، يعني: تخرصون كذبًا.
قال: {إنّ الّذين تعبدون من دون اللّه لا يملكون لكم رزقًا فابتغوا عند اللّه
[تفسير القرآن العظيم: 2/622]
الرّزق} [العنكبوت: 17] فإنّ هذه الأوثان لا تملك لكم رزقًا.
{واعبدوه واشكروا له} [العنكبوت: 17]، أي: فابتغوا عند اللّه الرّزق بأن تعبدوه وتشكروه يرزقكم.
قال: {إليه ترجعون} [العنكبوت: 17] يوم القيامة). [تفسير القرآن العظيم: 2/623]
قالَ يَحْيَى بْنُ زِيَادٍ الفَرَّاءُ: (ت: 207هـ)
: (وقوله: {إنّما تعبدون من دون اللّه أوثاناً وتخلقون إفكاً...}
{إنّما} في هذا الموضع حرفٌ واحدٌ، وليست على معنى (الذي) , {وتخلقون إفكاً} مردودة على (إنّما) , كقولك: إنما تفعلون كذا، وإنما تفعلون كذا, وقد اجتمعوا على تخفيف {تخلقون} إلاّ أبا عبد الرحمن السلمي ؛ فإنه قرأ : {وتخلّقون إفكاً} ينصب التاء ويشدّد اللام , وهما في المعنى سواء.). [معاني القرآن: 2/315]
قالَ أَبُو عُبَيْدَةَ مَعْمَرُ بْنُ الْمُثَنَّى التَّيْمِيُّ (ت:210هـ): ({ أوثاناً}: الوثن من حجارة , أو من جص.
{ وتخلقون إفكاً }, مجازه: تختلقون , وتفترون.
{واشكروا له}: واشكروه واحد.). [مجاز القرآن: 2/114]
قَالَ عَبْدُ اللهِ بنُ يَحْيَى بْنِ المُبَارَكِ اليَزِيدِيُّ (ت: 237هـ) : ({تخلقون إفكا}: تخلقون وتفترون واحد). [غريب القرآن وتفسيره: 295]
قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ قُتَيْبَةَ الدِّينَوَرِيُّ (ت: 276هـ) : ( الأوثان : واحدها: وثن, وهو: ما كان من حجارة أو جصّ.
{وتخلقون إفكاً}: أي : تختلقون كذباً.). [تفسير غريب القرآن: 337]
قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ قُتَيْبَةَ الدِّينَوَرِيُّ (ت: 276هـ): (الخلق: التّخرّص، قال الله تعالى: {إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ} أي: خرصهم للكذب.
وقال تعالى: {وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا}، أي تخرصون كذبا.
وقال تعالى: {إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ} أي: افتعال للكذب.
والعرب تقول للخرافات: أحاديث الخلق). [تأويل مشكل القرآن: 506] (م)
قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ السَّرِيِّ الزَّجَّاجُ (ت: 311هـ): (وقوله: {إنّما تعبدون من دون اللّه أوثانا وتخلقون إفكا إنّ الّذين تعبدون من دون اللّه لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند اللّه الرّزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون (17)}
وقرئت :{وتخلّقون إفكاً}: أوثاناً , أصناماً.
وتخلقون إفكا فيه قولان: تخلقون كذبا، وقيل : تعملون الأصنام، ويكون التأويل على هذا القول: إنما تعبدون من دون الله أوثانًا , وأنتم تصنعونها.). [معاني القرآن: 4/164-165]
قَالَ مَكِّيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ القَيْسِيُّ (ت: 437هـ): ({وتخلقون إِفْكًا}: تختلقون كذباً.). [تفسير المشكل من غريب القرآن: 185]
قَالَ مَكِّيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ القَيْسِيُّ (ت: 437هـ): ({تَخْلُقُونَ}: تكذبون.). [العمدة في غريب القرآن: 237]
تفسير قوله تعالى: (وَإِنْ تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (18) )
قال يَحيى بن سلاَّم بن أبي ثعلبة البصري (ت: 200هـ): (قال: {وإن تكذّبوا فقد كذّب أممٌ من قبلكم} [العنكبوت: 18]، أي: فأهلكهم اللّه، يحذّرهم أن ينزل بهم ما نزل بهم إن لم يؤمنوا.
قال: {وما على الرّسول إلا البلاغ المبين} [العنكبوت: 18] قال: ليس عليه أن يكره النّاس على الإيمان كقوله: {ولو شاء ربّك لآمن من في الأرض كلّهم جميعًا أفأنت} [يونس: 99] يقوله على الاستفهام: {تكره النّاس حتّى يكونوا مؤمنين} [يونس: 99]، أي: أنّك لا تستطيع أن تكرههم وإنّما يؤمن من أراد اللّه أن يؤمن وكقوله: {إنّك لا تهدي من أحببت ولكنّ اللّه يهدي من يشاء} [القصص: 56] ). [تفسير القرآن العظيم: 2/623]
تفسير قوله تعالى: {أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (19)}
قال يَحيى بن سلاَّم بن أبي ثعلبة البصري (ت: 200هـ): (قال: {أولم يروا كيف يبدئ اللّه الخلق} [العنكبوت: 19] بلى قد رأوا أنّ اللّه تبارك وتعالى خلق العباد.
قال: {ثمّ يعيده} [العنكبوت: 19]، يعني: البعث، يخبر أنّه يبعث العباد، والمشركون على خلاف ذلك لا يقرّون بالبعث.
قال: {إنّ ذلك على اللّه يسيرٌ} [العنكبوت: 19] خلقهم وبعثهم). [تفسير القرآن العظيم: 2/623]
قالَ أَبُو عُبَيْدَةَ مَعْمَرُ بْنُ الْمُثَنَّى التَّيْمِيُّ (ت:210هـ): ({ أولم يروا كيف يبدي اللّه الخلق }, مجازه: كيف استأنف الخلق الأول.
{ ثمّ بعيده}, بعد، يقال: رجع عوده على بدئه , أي : آخره , وعلى أوله، وفيه لغتان , يقال: أبدأ , وأعاد, وكان ذلك مبدئاً , ومعيداً , وبدأ , وعاد, وكان ذلك ادئاً , وعائداً.). [مجاز القرآن: 2/115]
قالَ الأَخْفَشُ سَعِيدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَلْخِيُّ (ت: 215هـ) : ({أولم يروا كيف يبدئ اللّه الخلق ثمّ يعيده إنّ ذلك على اللّه يسيرٌ * قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثمّ اللّه ينشئ النّشأة الآخرة إنّ اللّه على كلّ شيءٍ قديرٌ}
وقال: {كيف يبدئ اللّه} , وقال: {كيف بدأ الخلق} ؛ لأنهما لغتان , تقول: "بدأ الخلق" , و"أبدأ".). [معاني القرآن: 3/25-26] قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ السَّرِيِّ الزَّجَّاجُ (ت: 311هـ) : (وقوله: {أولم يروا كيف يبدئ اللّه الخلق ثمّ يعيده إنّ ذلك على اللّه يسير (19)}, وتقرأ : تروا بالتاء.). [معاني القرآن: 4/165]
تفسير قوله تعالى: {قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآَخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (20)}
قال يَحيى بن سلاَّم بن أبي ثعلبة البصري (ت: 200هـ): (ثمّ قال للنّبيّ عليه السّلام: {قل} لهم.
{سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق} [العنكبوت: 20] حيثما ساروا رأوا خلق اللّه الّذي خلق.
[تفسير القرآن العظيم: 2/623]
قال اللّه: {ثمّ اللّه ينشئ} [العنكبوت: 20] يخلق.
{النّشأة الآخرة} [العنكبوت: 20] الخلق الآخر، يعني: البعث، أي: أنّه خلقهم وأنّه يبعثهم.
{إنّ اللّه على كلّ شيءٍ قديرٌ}). [تفسير القرآن العظيم: 2/624]
قالَ يَحْيَى بْنُ زِيَادٍ الفَرَّاءُ: (ت: 207هـ)
: (وقوله: {النّشأة...}
القراء مجتمعون على جزم الشين , وقصرها، إلا الحسن البصريّ ؛ إنه مدّها في كل القرآن فقال : {النشاءة}, ومثلها مما تقوله العرب الرأفة، والرآفة، والكأبة والكآبة , كلّ صواب.). [معاني القرآن: 2/315]
قالَ أَبُو عُبَيْدَةَ مَعْمَرُ بْنُ الْمُثَنَّى التَّيْمِيُّ (ت:210هـ): ({كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النّشأة الآخرة }, مجاز { ينشيء }: يبدئ.). [مجاز القرآن: 2/115]
قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ السَّرِيِّ الزَّجَّاجُ (ت: 311هـ) : ( {قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثمّ اللّه ينشئ النّشأة الآخرة إنّ اللّه على كلّ شيء قدير (20)} {ثمّ اللّه ينشئ النّشأة الآخرة}: أي: ثم إن الله يبعثهم ثانية ينشئهم نشأة أخرى، كما قال:{وأنّ عليه النّشأة الأخرى (47)}
وأكثر القراءة : {النّشأة}بتسكين الشين , وترك لمدّه.
وقرأ أبو عمرو : {النشاءة الأخرى} بالمدّ.). [معاني القرآن: 4/165]
تفسير قوله تعالى: {يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ (21) }
قال يَحيى بن سلاَّم بن أبي ثعلبة البصري (ت: 200هـ): (قوله عزّ وجلّ: {يعذّب من يشاء ويرحم من يشاء} [العنكبوت: 21] يعذّب الكافر بالنّار، ويرحم المؤمن فيدخله الجنّة.
قال: {وإليه تقلبون} [العنكبوت: 21]، أي: وإليه ترجعون يوم القيامة). [تفسير القرآن العظيم: 2/624]
قالَ أَبُو عُبَيْدَةَ مَعْمَرُ بْنُ الْمُثَنَّى التَّيْمِيُّ (ت:210هـ)
: ({وإليه تقلبون}:أي : ترجعون.).
[مجاز القرآن: 2/115]
قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ قُتَيْبَةَ الدِّينَوَرِيُّ (ت: 276هـ) : ( {وإليه تقلبون} : أي : ترّدون.). [تفسير غريب القرآن: 337]
تفسير قوله تعالى: {وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (22)}
قال يَحيى بن سلاَّم بن أبي ثعلبة البصري (ت: 200هـ): (قوله عزّ وجلّ: {وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السّماء} [العنكبوت: 22] أي فتسبقونّا حتّى لا نقدر عليكم فنعذّبكم، يقوله للمشركين.
وقال السّدّيّ: {وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السّماء} [العنكبوت: 22]، يعني: ما أنتم بسابقي اللّه بأعمالكم الخبيثة، فتفوتوه هربًا.
قال: {وما لكم من دون اللّه من وليٍّ} [العنكبوت: 22]، يعني: من قريبٍ يمنعكم، يعني: الكفّار، تفسير السّدّيّ.
قال يحيى: يقول: {من وليٍّ} [العنكبوت: 22] يمنعكم من عذابه.
{ولا نصيرٍ} [العنكبوت: 22] ). [تفسير القرآن العظيم: 2/624]
قالَ يَحْيَى بْنُ زِيَادٍ الفَرَّاءُ: (ت: 207هـ)
: (وقوله: {وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السّماء...}
يقول: القائل: وكيف وصفهم أنهم لا يعجزون في الأرض , ولا في السماء، وليسوا من أهل السّماء؟ , فالمعنى - والله أعلم - : ما أنتم بمعجزين في الأرض , ولا من في السّماء بمعجزٍ, وهو من غامض العربيّة للضمير الذي لم يظهر في الثاني.
ومثله قول حسّان:
أمن يهجو رسول الله منكم = ويمدحه وينصره سواءٌ أراد: ومن ينصره , ويمدحه , فأضمر (من) وقد يقع في وهم السّامع أن المدح و, النصر لمن هذه الظاهرة, ومثله في الكلام: أكرم من أتاك وأتى أباك، وأكرم من أتاك ولم يأت زيداً، تريد: ومن لم يأت زيداً.). [معاني القرآن: 2/315]
قالَ الأَخْفَشُ سَعِيدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَلْخِيُّ (ت: 215هـ) : ({وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السّماء وما لكم مّن دون اللّه من وليٍّ ولا نصيرٍ}
وقال: {وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السّماء}: أي: لا تعجزوننا هرباً في الأرض , ولا في السّماء.). [معاني القرآن: 3/26]
قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ قُتَيْبَةَ الدِّينَوَرِيُّ (ت: 276هـ) : ({وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السّماء}: أي : ولا من في السماء بمعجز.). [تفسير غريب القرآن: 338]
قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ قُتَيْبَةَ الدِّينَوَرِيُّ (ت: 276هـ): (وقال تعالى: {وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السّماء}. أراد: ولا من في السماء بمعجز). [تأويل مشكل القرآن: 217]
قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ السَّرِيِّ الزَّجَّاجُ (ت: 311هـ): (وقوله تعالى: {وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السّماء وما لكم من دون اللّه من وليّ ولا نصير (22)}
أي : ليس يعجز اللّه خلق في السماء , ولا في الأرض.
وفي هذا قولان:
أحدهما : معناه ما أنتم بمعجزين في الأرض , ولا أهل السماء معجزين في السّماء، أي: من في السّماوات , ومن في الأرض غير معجزين .
ويجوز - والله أعلم -: وما أنتم بمعجزين في الأرض، ولا لو كنتم في السماء، أي : لا ملجأ من الله إلا إليه.). [معاني القرآن: 4/165]
قَالَ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيلَ النحَّاسُ (ت: 338هـ) : (وقوله جل وعز: {وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء} قال محمد بن يزيد : المعنى :ولا من في السماء , ومن نكرة , وأنشد غيره:
فمن يهجو رسول الله منكم = ويمدحه وينصره سواء
وقال غير أبي العباس : المعنى : وما أنتم بمعجزين في الأرض , ولو كنتم في السماء , وخوطب الناس على ما يعرفون , وهذا أولى , والله أعلم.). [معاني القرآن: 5/218]
تفسير قوله تعالى: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآَيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِي وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (23)}
قال يَحيى بن سلاَّم بن أبي ثعلبة البصري (ت: 200هـ): (قوله عزّ وجلّ: {والّذين كفروا بآيات اللّه ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي} [العنكبوت: 23]، يعني: من جنّتي.
{وأولئك لهم عذابٌ أليمٌ} [العنكبوت: 23]، يعني: موجعٌ، يعني: به عذاب جهنّم، وهو تفسير السّدّيّ.
عبد الرّحمن بن يزيد بن جابر بن أبي سلامٍ الشّاميّ قال: قال رسول اللّه
[تفسير القرآن العظيم: 2/624]
صلّى اللّه عليه وسلّم: خمسٌ من لقي اللّه تبارك وتعالى بهنّ مستيقنًا دخل الجنّة: من شهد أن لا إله إلا اللّه وأنّ محمّدًا رسول اللّه، وأيقن بالموت، والبعث والحساب.
- الخليل بن مرّة، وأبو أميّة، عن يحيى بن أبي كثيرٍ، عن زيد بن سلامٍ، عن أبي سلامٍ، عن ثوبان مولى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم، أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم، قال: «خمسٌ من أثقل شيءٍ في الميزان»، فقال رجلٌ: يا نبيّ اللّه ما هنّ؟ قال: «لا إله إلا اللّه، واللّه أكبر، والحمد للّه، وسبحان اللّه، والولد الصّالح يتوفّى فيحتسبه والده».
وخمسٌ من لقي اللّه تبارك وتعالى بهنّ موقنًا دخل الجنّة: من شهد أن لا إله إلا اللّه، وأنّ محمّدًا رسول اللّه، وأيقن بالموت، والبعث والحساب.
- سفيان الثّوريّ، عن منصورٍ، عن ربعيّ بن حراشٍ، عن عليٍّ قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: " لا يؤمن عبدٌ حتّى يؤمن بأربعةٍ: يشهد أن لا إله إلا اللّه، وأنّي رسول اللّه بعثني بالحقّ، ويؤمن بالبعث بعد الموت، ويؤمن بالقدر "). [تفسير القرآن العظيم: 2/625]
قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ السَّرِيِّ الزَّجَّاجُ (ت: 311هـ) : (وقوله عزّ وجلّ: {والّذين كفروا بآيات اللّه ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم (23)}
روي عن قتادة : أنه قال: (إن الله ذمّ قوما هانوا عليه , فقال: أولئك يئسوا من رحمتي), وقال: (إنّه لا ييأس من روح اللّه إلّا القوم الكافرون)
وينبغي للمؤمن ألا ييئس من روح الله، ولا من رحمته، ولا يأمن من عذابه وعقابه، وصفة المؤمن : أن يكون راجيًا للّه، خائفاً.). [معاني القرآن: 4/165]
تفسير قوله تعالى: {فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (24) }
قال يَحيى بن سلاَّم بن أبي ثعلبة البصري (ت: 200هـ): (قوله عزّ وجلّ: {فما كان جواب قومه} [العنكبوت: 24] رجع إلى قصّة إبراهيم: {وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا اللّه واتّقوه} [العنكبوت: 16] قال: {فما كان جواب قومه} [العنكبوت: 24] قوم إبراهيم.
{إلا أن قالوا اقتلوه أو حرّقوه} [العنكبوت: 24] يقوله بعضهم لبعضٍ.
قال: {فأنجاه اللّه من النّار} [العنكبوت: 24] وقد فسّرنا ذلك في سورة الأنبياء.
قال: {إنّ في ذلك لآياتٍ لقومٍ يؤمنون} [العنكبوت: 24]، أي: فيما صنع اللّه بإبراهيم وما
[تفسير القرآن العظيم: 2/625]
نجّاه من النّار، وإنّما يعتبر المؤمنون). [تفسير القرآن العظيم: 2/626]
قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ السَّرِيِّ الزَّجَّاجُ (ت: 311هـ) : ( {فما كان جواب قومه إلّا أن قالوا اقتلوه أو حرّقوه , فأنجاه اللّه من النّار إنّ في ذلك لآيات لقوم يؤمنون (24)}
وقرأ الحسن : (فما كان جواب قومه) بالرفع , فمن نصب جعل " أن قالوا " اسم كان، ومن رفع الجواب , جعله اسم كان , وجعل الخبر " أن قالوا " , وما عملت فيه، ويكون المعنى : ما كان الجواب إلا مقالتهم: اقتلوه، لما أن دعاهم إبراهيم إلى توحيد اللّه عزّ وجلّ، واحتجّ عليهم بأنهم يعبدون ما لا يضرهم , ولا ينفعهم، جعلوا الجواب اقتلوه أو حقوه.
وقوله: {فأنجاه اللّه من النّار}: المعنى : فحرقوه , فأنجاه اللّه من النّار.
ويروى: أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم لم تعمل النار في شيء منه إلا في وثاقه الذي شدّ به. ويروى: أن جميع الدواب, والهوام كانت تطفئ عن إبراهيم إلا الوزغ، فإنها كانت تنفخ النار، فأمر بقتلها , ويرد أنه لم ينتفع في ذلك اليوم بالنار، أعني : يوم أخذوا إبراهيم عليه السلام.
وجميع ما ذكرناه في هذه القصة , مما رواه عبد اللّه بن أحمد بن حنبل عن أبيه، وكذلك أكثر ما رويت في هذا الكتاب من التفسير.
فهو من كتاب التفسير , عن أحمد بن حنبل). [معاني القرآن: 4/166]
قَالَ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيلَ النحَّاسُ (ت: 338هـ) : (وقوله جل وعز: {فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار}
المعنى : فحرقوه , فأنجاه الله من النار , ويروى: أنه لم تحرق إلا وثاقه.). [معاني القرآن: 5/219]
تفسير قوله تعالى: {وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ومَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ (25)}
قال يَحيى بن سلاَّم بن أبي ثعلبة البصري (ت: 200هـ): (وقال إبراهيم.
{إنّما اتّخذتم من دون اللّه أوثانًا مودّة بينكم} [العنكبوت: 25] يوادّ بعضكم بعضًا، أي: يحبّ بعضكم بعضًا على عبادة الأوثان.
{في الحياة الدّنيا ثمّ يوم القيامة يكفر بعضكم ببعضٍ} [العنكبوت: 25]، أي: بولاية بعضٍ.
وقال السّدّيّ: يتبرّأ بعضكم من بعضٍ.
{ويلعن بعضكم بعضًا ومأواكم النّار وما لكم من ناصرين} [العنكبوت: 25] ). [تفسير القرآن العظيم: 2/626]
قالَ يَحْيَى بْنُ زِيَادٍ الفَرَّاءُ: (ت: 207هـ): (وقوله: {وقال إنّما اتّخذتم مّن دون اللّه أوثاناً مّودّة بينكم...}
نصبها حمزة وأضافها؛ ونصبها عاصم , وأهل المدينة، ونوّنوا فيها : {أوثاناً مّودّة بينكم} , ورفع ناسٌ منهم الكسائيّ بإضافة, وقرأ الحسن : {مودّةٌ بينكم}, يرفع ولا يضيف, وهي في قراءة أبيّ:{إنّما مودّة بينهم في الحياة الدّنيا}.
وفي قراءة عبد الله : (إنّما مودّة بينكم), وهما شاهدان لمن رفع, فمن رفع , فإنما يرفع بالصفة بقوله: {في الحياة الدّنيا} , وينقطع الكلام عند قوله: {إنّما اتّخذتم مّن دون اللّه أوثاناً} .
ثم قال: ليست مودّتكم تلك الأوثان , ولا عبادتكم إيّاها بشيء، إنّما مودّة ما بينكم في الحياة الدنيا , ثم تنقطع, ومن نصب أوقع عليها الاتّخاذ: إنما اتّخذتموها مودّةً بينكم في الحياة الدنيا. وقد تكون رفعاً على أن تجعلها خبراً لما , وتجعل (ما) على جهة (الذي) ؛ كأنك قلت: إن الذين اتخذتموهم أوثاناً مودّة بينكم , فتكون المودّة كالخبر، ويكون رفعها على ضمير (هي) كقوله: {لم يلبثوا إلاّ ساعةً من نهارٍ} .
ثم قال {بلاغٌ} : أي: هذا بلاغ، ذلك بلاغ, ومثله : {إنّ الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون} . ثم قال: {متاعٌ في الدنيا}: أي: ذلك متاع في الحياة الدنيا , وقوله: {يكفر بعضكم ببعضٍ}: يتبرّأ بعضكم من بعضٍ , والعابد والمعبود في النار.). [معاني القرآن: 2/315-316]
قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ السَّرِيِّ الزَّجَّاجُ (ت: 311هـ) : (وقال عزّ وجلّ: {وقال إنّما اتّخذتم من دون اللّه أوثانا مودّة بينكم في الحياة الدّنيا ثمّ يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النّار وما لكم من ناصرين (25)}
أي : قال إبراهيم لقومه : إنما اتخذتم هذه الأوثان ؛ لتتوادّوا بها في الحياة الدنيا.
{ثمّ يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا}, وهذا كما قال الله - عزّ وجلّ: {الأخلّاء يومئذ بعضهم لبعض عدوّ إلّا المتّقين (67)}
وفيها في القراءة أربعة أوجه, منها: {مودّة بينكم}, بفتح (مودّة), وبالإضافة إلى بين، وبنصب مودّة والتنوين، ونصب بين{مودّة بينكم}.
ويجوز {مودّة بينكم} بالرفع , والإضافة إلى بين.
ويجوز {مودّة بينكم} بالرفع , والتنوين , ونصب بين.
فالنصب في {مودّة} من أجل أنها مفعول لها، أي : اتخذتم هذا للمودة بينكم, ومن رفع فمن جهتين:
إحداهما : أن يكون " ما " في معنى " الذي " , يكون المعنى: إن ما اتخذتموه من دون الله أوثانا مودة بينكم، فيكون{مودّة} خبر إن، .
ويكون برفع {مودّة} على إضمار هي، كأنه قال: تلك مودة بينكم في الحياة الدنيا، أي: ألفتكم , واجتماعكم على الأصنام مودّة بينكم في الحياة الدنيا.). [معاني القرآن: 4/166-167]
تفسير قوله تعالى:{فَآَمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (26) }
قال يَحيى بن سلاَّم بن أبي ثعلبة البصري (ت: 200هـ): (قال: {فآمن له لوطٌ} [العنكبوت: 26]، أي: فصدّقه لوطٌ.
{وقال إنّي مهاجرٌ إلى ربّي} [العنكبوت: 26] يقوله إبراهيم.
{إنّه هو العزيز الحكيم} [العنكبوت: 26] هاجر من أرض العراق إلى أرض الشّام). [تفسير القرآن العظيم: 2/626]
قالَ يَحْيَى بْنُ زِيَادٍ الفَرَّاءُ: (ت: 207هـ): (وقوله: {إنّي مهاجرٌ إلى ربّي...} هذا من قيل إبراهيم, وكان مهاجره من حرّان إلى فلسطين.). [معاني القرآن: 2/316]
قالَ أَبُو عُبَيْدَةَ مَعْمَرُ بْنُ الْمُثَنَّى التَّيْمِيُّ (ت:210هـ): ({ وقال إنّي مهاجرٌ إلى ربّي }: كل من خرج من داره , أو قطع شيئاً , فقد هاجر , ومنه: مهاجر , والمسلمين.). [مجاز القرآن: 2/115]
قَالَ عَبْدُ اللهِ بنُ يَحْيَى بْنِ المُبَارَكِ اليَزِيدِيُّ (ت: 237هـ) : ({مهاجر إلى ربي}: كل من خرج من داره إلى دار أو قطع شيئا فقد هاجر، والمهاجرون من ذلك). [غريب القرآن وتفسيره: 295] قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ السَّرِيِّ الزَّجَّاجُ (ت: 311هـ): (وقوله عزّ وجلّ:{فآمن له لوط وقال إنّي مهاجر إلى ربّي إنّه هو العزيز الحكيم (26)}صدّق لوط إبراهيم عليه السلام، وقال: {إنّي مهاجر إلى ربّي}. إبراهيم هاجر من كوثى إلى الشام.). [معاني القرآن: 4/167]
قَالَ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيلَ النحَّاسُ (ت: 338هـ) : (وقوله جل وعز: {فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي}
قال الضحاك : (إبراهيم هاجر , وهو أول من هاجر) .
وقال قتادة : (هاجر من كوثى إلى الشام)). [معاني القرآن: 5/219]
قَالَ مَكِّيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ القَيْسِيُّ (ت: 437هـ): ( {مُهَاجِرٌ}: خارج.). [العمدة في غريب القرآن: 237]
تفسير قوله تعالى: {وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآَتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآَخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ (27)}
قال يَحيى بن سلاَّم بن أبي ثعلبة البصري (ت: 200هـ): (قال: {ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذرّيّته النّبوّة والكتاب} [العنكبوت: 27] فكان أوّل كتابٍ أنزل بعد كتاب موسى وما بعده من الكتب.
حدّثنا أبو القاسم الفروبيّ: قال: حدّثنا الحسن بن عليّ بن عفّان، قال: حدّثنا معاوية بن هشامٍ، قال: حدّثنا سفيان، عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ: {وآتيناه أجره في الدّنيا} [العنكبوت: 27] قال: الثّناء.
قال: {واجعل لي لسان صدقٍ في الآخرين} [الشعراء: 84] قال: الثّناء.
قال: {وآتيناه أجره} [العنكبوت: 27] أعطيناه أجره.
{في الدّنيا} [العنكبوت: 27] فليس من أهل دينٍ إلا وهم يتولّونه ويحبّونه وهو مثل قوله: {وتركنا عليه في الآخرين} [الصافات: 78]، أي: أبقينا عليه في الآخرين الثّناء الحسن.
[تفسير القرآن العظيم: 2/626]
قال: {وإنّه في الآخرة لمن الصّالحين} [العنكبوت: 27] لمن أهل الجنّة). [تفسير القرآن العظيم: 2/627]
قالَ يَحْيَى بْنُ زِيَادٍ الفَرَّاءُ: (ت: 207هـ): (وقوله: {وآتيناه أجره في الدّنيا...} الثناء الحسن وأن أهل الأديان كلّهم يتولّونه, ومن أجره أن جعلت النبوّة , والكتاب في ذرّيته.). [معاني القرآن: 2/316]
قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ قُتَيْبَةَ الدِّينَوَرِيُّ (ت: 276هـ) : ( {آتيناه أجره في الدّنيا}: بالولد الطّيب، وحسن الثناء عليه.). [تفسير غريب القرآن: 338]
قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ السَّرِيِّ الزَّجَّاجُ (ت: 311هـ) : (وقوله: {ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذرّيّته النّبوّة والكتاب وآتيناه أجره في الدّنيا وإنّه في الآخرة لمن الصّالحين (27)} {وآتيناه أجره في الدّنيا}:قيل : الذكر الحسن، وكذلك : {وتركنا عليه في الآخرين}
وقيل : {وآتيناه أجره في الدّنيا}: أنه ليس من أمة من المسلمين , واليهود , والمجوس , والنصارى إلا وهم يعظمون إبراهيم.
وقيل: {وآتيناه أجره في الدّنيا} : أن الأنبياء من ولده، وقيل : الولد الصالح.). [معاني القرآن: 4/167-168]
قَالَ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيلَ النحَّاسُ (ت: 338هـ) : (وقوله جل وعز: {وآتيناه أجره في الدنيا}
روى سفيان , عن حميد بن قيس قال: أمر سعيد بن جبير إنسانًا أن يسأل عكرمة عن قوله تعالى: {وآتيناه أجره في الدنيا}
فقال عكرمة : (أهل الملل كلها تدعيه , وتقول: هو منا) , فقال سعيد بن جبير : (صدق) .
وقال قتادة: (هو مثل قوله تعالى:{وآتيناه في الدنيا حسنة} أي : عافية , وعملا صالحا , وثناء حسنا و, ذاك أن أهل كل دين يتولونه).
وقيل :{وآتيناه أجره في الدنيا }: إن أكثر الأنبياء من ولده.). [معاني القرآن: 5/219-220]
قَالَ مَكِّيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ القَيْسِيُّ (ت: 437هـ): ( {وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا}: أي :بالولد الطيب , وحسن الثناء.). [تفسير المشكل من غريب القرآن: 185]
تفسير قوله تعالى: {وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ (28)}
قال يَحيى بن سلاَّم بن أبي ثعلبة البصري (ت: 200هـ): (قوله عزّ وجلّ: {ولوطًا}، أي: وأرسلنا لوطًا.
قال: {إذ قال لقومه إنّكم لتأتون الفاحشة} [العنكبوت: 28] والفاحشة المعصية.
وهي إتيان الرّجال في أدبارهم، وهو تفسير السّدّيّ.
{ما سبقكم بها من أحدٍ من العالمين {28}). [تفسير القرآن العظيم: 2/627]
قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ السَّرِيِّ الزَّجَّاجُ (ت: 311هـ) : (وقوله تعالى:{ولوطاً إذ قال لقومه إنّكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين (28)}
المعنى : أنه لم ينز ذكر على ذكر قبل قوم لوط.). [معاني القرآن: 4/168]
قَالَ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيلَ النحَّاسُ (ت: 338هـ) : (وقوله جل وعز: {ولوطاً إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين}
يروى: أنهم أول من نزا على الرجال.). [معاني القرآن: 5/221]
تفسير قوله تعالى: {أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (29)}
قال يَحيى بن سلاَّم بن أبي ثعلبة البصري (ت: 200هـ): ({أئنّكم لتأتون الرّجال} [العنكبوت: 29] في أدبارهم، وهذا على الاستفهام، أي: أنّكم تفعلون ذلك.
قال: {وتقطعون السّبيل} [العنكبوت: 29] على الغرباء، فتأتونهم في أدبارهم، وكانوا لا يفعلون ذلك إلا بالغرباء، وكانوا يتعرّضون الطّرق، ويأخذون الغرباء ولا يفعله بعضهم ببعضٍ.
قال: {وتأتون في ناديكم المنكر} [العنكبوت: 29] في مجمعكم والمنكر الفاحشة، يعني: فعلهم ذلك.
{فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب اللّه إن كنت من الصّادقين} [العنكبوت: 29] وذلك لما كان يعدهم به من العذاب). [تفسير القرآن العظيم: 2/627]
قالَ يَحْيَى بْنُ زِيَادٍ الفَرَّاءُ: (ت: 207هـ): (وقوله: {وتقطعون السّبيل...} قطعه: أنهم كانوا يعترضون الناس من الطرق بعملهم الخبيث، يعني : اللواط, ويقال: وتقطعون السّبيل: تقطعون سبيل الولد بتعطيلكم النساء .
وقوله: {وتأتون في ناديكم المنكر} في مجالسكم., والمنكر منه الخذف، والصفير، ومضغ العلك، وحلّ أزرار الأقبية والقمص، والرمي بالبندق. ويقال: هي ثماني عشرة خصلةً من قول الكلبيّ لا أحفظها.
وقال غيره: هي عشر.). [معاني القرآن: 2/316-317]
قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ قُتَيْبَةَ الدِّينَوَرِيُّ (ت: 276هـ) : ({وتأتون في ناديكم المنكر}, و«النادي»: المجلس, و«المنكر» : جمع الفواحش من القول , والفعل, وقد اختلف في ذلك المنكر.). [تفسير غريب القرآن: 338] قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ السَّرِيِّ الزَّجَّاجُ (ت: 311هـ) : (وقوله:{أئنّكم لتأتون الرّجال وتقطعون السّبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلّا أن قالوا ائتنا بعذاب اللّه إن كنت من الصّادقين (29)} اللفظ : لفظ استفهام، والمعنى : معنى التقرير والتوبيخ.
{وتقطعون السّبيل}: جاء في التفسير : ويقطعون سبيل الولد، وقيل: يعترضون الناس في الطرق لطلب الفاحشة.
{وتأتون في ناديكم المنكر}: أي: تأتون في مجالسكم المنكر، قيل : إنهم كانوا يخذفون الناس في مجالسهم , ويسخرون منهم، فأعلم اللّه جلّ وعرأن هذا من المنكر، وأنه لا ينبغي أن تتعاشر الناس عليه، ولا يجتمعوا إلا فيما قرّب إلى اللّه , وباعد من سخطه، وألّا يجتمعوا على الهزء , والتلهّي.
وقيل : {وتأتون في ناديكم المنكر}: أنهم كانوا يفسقون في مجالسهم.). [معاني القرآن: 4/168]
قَالَ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيلَ النحَّاسُ (ت: 338هـ) : (ثم قال جل وعز: {أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل}
استفهام فيه معنى التوبيخ والتقرير
وقوله جل وعز: {وتقطعون السبيل} قيل : كانوا يتلقون الناس من الطرق للفساد , وقيل: أي: تقطعون سبيل الولد .
ثم قال جل وعز: {وتأتون في ناديكم المنكر}
قال مجاهد : (النادي : المجلس , والمنكر فعلهم بالرجال) .
قال أبو جعفر : المنكر في اللغة : يقع على القول الفاحش , وعلى الفعل .
حدثنا محمد بن إدريس بن الأسود , قال : حدثنا إبراهيم بن مرزوق, قال : حدثنا عبد الله بن بكر , قال: حدثنا حاتم بن أبي صغيرة , عن سماك , عن أبي صالح مولى أم هانئ ابنة أبي طالب رضي الله عنها : (أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: قلت : يا رسول الله, أرأيت قول الله عز وجل: {وتأتون في ناديكم المنكر}, ما كان ذلك المنكر الذي كانوا يأتونه في ناديهم ؟.
قال: ((كانوا يضحكون بأهل الطريق , ويحذفونهم .))).
قال أبو جعفر : فسمى الله جل وعز هذا منكرا لأنه لا ينبغي للناس أن يتعاشروا به .
وحدثنا أسامة بن أحمد , قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم , عن يزيد بن بكير , عن القاسم بن محمد في قوله تعالى: {وتأتون في ناديكم المنكر}, قال: (كانوا يتفاعلون في مجالسهم يفعل بعضهم على بعض).
قال أبو جعفر : قالها الشيخ بالضاد , والطاء.). [معاني القرآن: 5/221-223]
قَالَ غُلاَمُ ثَعْلَبٍ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الوَاحِدِ البَغْدَادِيُّ (ت:345 هـ) : ( {فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ}: أي: في مجلسكم.). [ياقوتة الصراط: 401]
قَالَ مَكِّيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ القَيْسِيُّ (ت: 437هـ): ( (النادي): المجلس.). [تفسير المشكل من غريب القرآن: 185]
تفسير قوله تعالى: (قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ (30) )
قال يَحيى بن سلاَّم بن أبي ثعلبة البصري (ت: 200هـ): (قال لوطٌ.
{ربّ انصرني على القوم المفسدين} [العنكبوت: 30] المشركين وهو أعظم الفساد، والمعاصي كلّها من الفساد، وأعظمها الشّرك، وكانوا على الشّرك، جاحدين نبيّهم). [تفسير القرآن العظيم: 2/627]
تفسير قوله تعالى: (وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ (31) )
قال يَحيى بن سلاَّم بن أبي ثعلبة البصري (ت: 200هـ): (قال اللّه: {ولمّا جاءت رسلنا} [العنكبوت: 31]، يعني: الملائكة.
[تفسير القرآن العظيم: 2/627]
{إبراهيم بالبشرى} [العنكبوت: 31] بإسحاق، وذلك أنّ الملائكة، لمّا بعثت إلى قوم لوطٍ بعذابهم مرّوا بإبراهيم، فسألوه الضّيافة، فلمّا أخبروه أنّهم أرسلوا بعذاب قوم لوطٍ بعد ما بشّروه بإسحاق {قالوا إنّا مهلكو أهل هذه القرية} [العنكبوت: 31]، يعني: قوم لوطٍ.
{إنّ أهلها كانوا ظالمين} [العنكبوت: 31]، يعني: مشركين). [تفسير القرآن العظيم: 2/628]
تفسير قوله تعالى: {قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ (32) }
قال يَحيى بن سلاَّم بن أبي ثعلبة البصري (ت: 200هـ): ({قال} إبراهيم لهم.
{إنّ فيها لوطًا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجّينّه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين} [العنكبوت: 32] الباقين في عذاب اللّه، وقال في آيةٍ أخرى: {إلا امرأته قدّرنا إنّها لمن الغابرين} [الحجر: 60] ). [تفسير القرآن العظيم: 2/628]
قَالَ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيلَ النحَّاسُ (ت: 338هـ) : (وقوله عز وجل: {قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها}
روى أبو نصر , عن عبد الرحمن بن سمرة قال: (قال إبراهيم صلى الله عليه وسلم للملائكة:إن كان فيهم مائة يكرهون هذا , أتهلكونهم ؟.
قالوا : لا .
قال : فإن كان فيهم تسعون ؟. قالوا : لا .
إلى أن بلغ عشرين , قال : {إن فيها لوطاً} .
قالت الملائكة صلى الله عليهم :{نحن أعلم بمن فيها }) قال عبد الرحمن : (وكانوا أربعمائة ألف)). [معاني القرآن: 5/225]
تفسير قوله تعالى: {وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِن الْغَابِرِينَ (33)}َ
قال يَحيى بن سلاَّم بن أبي ثعلبة البصري (ت: 200هـ): (قال: {ولمّا أن جاءت رسلنا} [العنكبوت: 33]، يعني: الملائكة.
{لوطًا سيء بهم وضاق بهم ذرعًا} [العنكبوت: 33] سيء بقومه الظّنّ بما كانوا يأتون الرّجال في أدبارهم تخوّفًا على أضيافه، وهو يظنّ أنّهم آدميّون.
قال: {وضاق بهم ذرعًا} [العنكبوت: 33] ضاق بأضيافه الذّرع لما يتخوّف عليهم منهم.
وقالوا الملائكة قالته للوطٍ.
{لا تخف ولا تحزن إنّا منجّوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين {33}). [تفسير القرآن العظيم: 2/628]
قالَ أَبُو عُبَيْدَةَ مَعْمَرُ بْنُ الْمُثَنَّى التَّيْمِيُّ (ت:210هـ): ({إنّا منجّوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين }, أي: من الباقين الذين طالت أعمارهم فبقيت ثم أهلكت، قال العجاج:
فما ونى محمدٌ مذ أن غفر= له الإله ما مضى وما غبر
وإذا كانت امرأة مع رجال كانت صفاتهم صفات الرجال , كقولك: عجوزاً من الغابرين، وقوله: { كانت من القانتين} {سيء بهم }, مجازه: فعل بهم من سؤت بنا.). [مجاز القرآن: 2/115]
قالَ الأَخْفَشُ سَعِيدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَلْخِيُّ (ت: 215هـ) : ({ولمّا أن جاءت رسلنا لوطاً سيء بهم وضاق بهم ذرعاً وقالوا لا تخف ولا تحزن إنّا منجّوك وأهلك إلاّ امرأتك كانت من الغابرين} وقال: {إنّا منجّوك وأهلك إلاّ امرأتك} ؛ لأنّ الأول كان في معنى التنوين ؛ لأنه لم يقع , فلذلك انتصب الثانني.). [معاني القرآن: 3/26] قَالَ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيلَ النحَّاسُ (ت: 338هـ) : (وقوله جل وعز: {ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا}
قال قتادة : (أي: ساء ظنه بقومه , وضاق ذرعه بضيفه) .
قال أبو جعفر : يقال : ضقت به ذرعا , أي : لم أطقه مشتق من الذراع ؛لأن القوة فيه.). [معاني القرآن: 5/224-225]
تفسير قوله تعالى: (إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (34) )
قال يَحيى بن سلاَّم بن أبي ثعلبة البصري (ت: 200هـ): ({إنّا منزلون على أهل هذه القرية رجزًا من السّماء} [العنكبوت: 34] يعنون قرية قوم لوطٍ {رجزًا} [العنكبوت: 34] عذابًا.
{بما كانوا يفسقون} [العنكبوت: 34] يشركون). [تفسير القرآن العظيم: 2/628]
تفسير قوله تعالى:{وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آَيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (35)}
قال يَحيى بن سلاَّم بن أبي ثعلبة البصري (ت: 200هـ): (قال اللّه: {ولقد تركنا منها آيةً} [العنكبوت: 35]، أي: عبرةً لقومٍ: تفسير مجاهدٍ والسّدّيّ.
قال: {بيّنةً لقومٍ يعقلون} [العنكبوت: 35] وهم المؤمنون، عقلوا عن اللّه ما أنزل عليهم، فأخبرهم أنّه جعل عاليها سافلها، خسف بهم وأمطر عليهم الحجارة). [تفسير القرآن العظيم: 2/629]
قالَ أَبُو عُبَيْدَةَ مَعْمَرُ بْنُ الْمُثَنَّى التَّيْمِيُّ (ت:210هـ)
: ({ تركنا منها آيةً }, مجازه: أبقينا منها علامة.)
[مجاز القرآن: 2/115]
قَالَ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيلَ النحَّاسُ (ت: 338هـ) : (وقوله جل وعز: {ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون}
قال مجاهد : (آية بينة , أي: عبرة) .
وقال قتادة : (هي الحجارة التي أبقيت).
وقال غيره : يرجم بها قوم من هذه الأمة.). [معاني القرآن: 5/225]